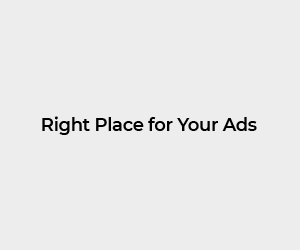الأحد 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021
واجهت السلطة السورية أحداث 1979-1982 الداخلية ضد الإسلاميين المسلحين عبر اقتصاد قوي وقاعدة اجتماعية قوية وعلاقات دولية – إقليمية داعمة امتدت من واشنطن والرياض إلى موسكو. ولم يكن هذا متوفراً للسلطة السورية عند نشوب الأزمة السورية بدءاً من درعا في الثامن عشر من آذار/مارس 2011.
عام 1991 بدأ انفتاح اقتصادي في سورية أعطى “اقتصاد السوق” مجالاً واسعاً على حساب “قطاع الدولة في الاقتصاد”، وفي عام 2004 انطلقت عملية لبرلة واسعة للاقتصاد السوري. كان هناك زيادة في نمو الفقر في فترتي 1996-2004 و2004-2007.
وكان ملفتاً أن الفقر كان منتشراً أكثر في الريف عام 2004، وأن مناطق الشمال والشرق، أي إدلب وحلب والرقة ودير الزور والحسكة، كانت الأشد فقراً، وفي حين أن نسبة الفقر الشديد في عموم سورية كانت في 2003-2004 بحدود 11,4%، فإن الفقر زاد في مناطق ريف الشمال والشرق بفترة 1997-2004 من 15,2% إلى 18%، و”حيث أن 44% من السكان يعيشون في الشمال والشرق فالفقر هناك يعادل 56% من مجموع الفقراء في سوريا، كما كانت مناطق الشمال والشرق الريفية هي الوحيدة التي عانت من زيادة الفقر بين العامين 1997-2004.
ويلاحظ في عملية نمو 2004-2007 التي أتت مع الليبرالية الاقتصادية غير المسبوقة منذ الثامن من آذار/مارس 1963، أنها كانت “مترافقة مع ظاهرتين: تحسن في الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة الفقر، أي زيادة في الفوارق الطبقية، وكانت مكاسب الأغنياء أكثر من تلك الاجراءات الحكومية.
وفي الفترة ما بين 2001و2010 شهدت سوريا 60 عاصفة غبارية، نتج عنها اقتلاع سطح التربة، كما أن جفاف 2006-2010 قد قاد في الريف إلى فقدان 800 ألف شخص لسبل الرزق وإلى ترك 200 ألف لأراضيهم، وفي هذا الصدد فإن “مراقبين خارجيين بما فيهم خبراء الأمم المتحدة قدروا بأن 2-3 مليون من ضمن 10 ملايين من القاطنين في المناطق الريفية قد أصبحوا في وضع من الفقر الأقصى”.
وكانت سوريا ومنطقة الهلال الخصيب قد عانتا من الجفاف في فترة 1998-2009 وهذا قاد إلى نزوح 1,5 مليون شخص من الريف إلى المناطق الحضرية الجنوبية.
تلقى الفلاحون السوريون ضربة بزيادة سعر ليتر المازوت من سبعة ليرات إلى 25 ليرة (نصف دولار) يوم الثاني من أيار/مايو 2008، وخاصة الفلاحون في شرق الفرات حيث القمح والشعير والقطن ،وقد ترك الكثيرون منهم محاصيلهم بدون سقاية أو حصاد.
من يراقب الخريطة الجغرافية للحراك السوري المعارض عام 2011 يراه متركزاً في المناطق الريفية، أي ريف منطقة حوران وبلداتها وريف دمشق وريف حمص وريف حماة وريف إدلب وبلداتها وريف حلب وريف دير الزور، مع وقوف تجار وصناعيي مدينتي دمشق وحلب مع السلطة.
كان هناك مدن متحركة مثل درعا وحمص ودير الزور ومدينة حماة في شهري حزيران/ يونيو وتموز/يوليو 2011، عندما كانت المظاهرات سلمية، ثم تجنبت على ما يبدو انطلاقاً من تجربتها في شباط/فبراير 1982، الانخراط في العمل المسلح الذي بدأ خريف العام 2011 في مناطق ريفية سورية عديدة منها ريف حماة.
ففي أعوام 1979-1982 استند “الإخوان المسلمون” في تحركهم إلى قاعدة اجتماعية في الأحياء القديمة من مدن حماة وحلب واللاذقية، وإلى بلدات إدلب التي كانت متضررة من المسار الاقتصادي – الاجتماعي – الثقافي – الإداري – السياسي الذي بدأ في الثامن من آذار/مارس 1963، فيما كان الريف وتجار دمشق مع السلطة ضد الإسلاميين.
كل قادة العمل المسلح الإسلامي المعارض في السبعينيات والثمانينيات أبناء مدن، مثل مروان حديد وعبد الستار الزعيم وعمر جواد (حمويون) وحسني عابو ومصطفى قصار (حلبيان) .كانت حالة عدنان عقلة ملفتة من خلال كونه من نازحي الجولان مع تسجيل أنه كان حلبي المنشأ وصاهر عائلة حلبية هي آل خير الله.
انعكست الصورة عام 2011 وما بعده، حيث كانت قاعدة الاحتجاجات المعارضة في الريف أساساً، ثم لاقى العمل المسلح المعارض قاعدة اجتماعية قوية في أرياف دمشق وإدلب وحلب ودير الزور ، وكل قادة العمل المسلح المعارض من أصل ريفي: حسان عبود وهاشم الشيخ وصالح الطحان وعبد القادر صالح وزهران علوش . تشبه حالة أبو محمد الجولاني (أحمد حسين الشرع: مواليد ما بين 1975- 1979، ابن أسرة نازحة من الجولان عام 1967 لتقيم في مدينة دمشق، وهو ابن أسرة كان والده موظفاً كخبير اقتصادي عند الحكومة. ذهب أحمد الشرع للعراق بعد الغزو الأميركي عام 2003،ثم أرسله أبو بكر البغدادي ، زعيم “دولة العراق الإسلامية”، أواخر عام 2011 ليقيم “جبهة النصرة”) ما كانته حالة عدنان عقلة.
وفي فترة ما بعد 2011 كانت الراية الأساسية للعمل المسلح هي الأيديولوجية السلفية – الجهادية، وهي تقليدياً ذات قاعدة اجتماعية ريفية مثل صعيد مصر بالنسبة لـ”الجماعة الإسلامية”، فيما كان العمل المسلح السوري المعارض في السبعينيات والثمانينيات تحت راية الأصولية الإسلامية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين بتفرعاتها المنشقة عن بعضها البعض (“تنظيم الطليعة” بزعامة مروان حديد – عبد الستار الزعيم – عمر جواد، و”التنظيم العام لجماعة الإخوان المسلمين” الذي تزعمه عدنان سعد الدين وهو حموي أيضاً مثل الثلاثة المذكورين، ولو أنه بالأصل من بلدة الرستن، قبل أن يتحد التنظيمان في كانون الأول/ديسمبر 1980).
كان تنظيم الإخوان المسلمين في سوريا يستند إلى قاعدة اجتماعية مدينية مثل مصر، لذلك كان قوياً في أحداث 1979- 1982 التي تركزت في مدن معينة، وضعيفاً من حيث القاعدة الاجتماعية في أزمة 2011-2021 حيث كان السلفيون – الجهاديون أقوى منه بحكم استناداتهم الاجتماعية في أرياف سورية عديدة.
يمكن أن يضاف للخلفية الاقتصادية الداخلية للأزمة السورية عامل اقتصادي خارجي، يتمثل في ما ذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، في عدد الثلاثين من آب/أغسطس 2013، عن أن السلطة السورية قد رفضت عرضاً قطرياً عام 2009 لمشروع من أجل نقل الغاز القطري إلى أوروبا عبر أنبوب يمتد من قطر للسعودية والأردن وسوريا حتى تركيا ومن الأخيرة إلى أوروبا، ليكون بديلاً عن خط الغاز الروسي الذي كان آنذاك (وما زال حتى الآن في عام 2021) هو المزود الرئيس للأوروبيين بالغاز، وهو ما كان سيشكل مكسباً استراتيجياً للغرب الأوروبي – الأميركي وضربة كبرى لموسكو.
كتكثيف: عندما اشتعل الحريق السوري ابتداء من يوم الثامن عشر من آذار/مارس 2011 في درعا، كانت هناك رياح “الربيع العربي” التي أشعلت حطباً سورياً كثيراً كان قابلاً للاشتعال معظمه موجود في الريف السوري السني. بعد مظاهرات سلمية في ربيع وصيف 2011 وضحت سيطرة الاسلاميين على الحراك السوري المعارض منذ خريف 2011 مع تغلب من يريدون السلاح المعارض على من يريدون سلمية الحراك، وفي فترة 2012-2015 سيطر السلفيون الجهاديون على المعارضة السورية المسلحة وكانوا واجهتها الأمامية.
لم يكن هناك مانع عند الدول (فرنسا وقطر وتركيا والسعودية والولايات المتحدة) التي خطبت ود سوريا في فترة أيار/مايو 2008 – كانون الثاني/يناير 2011 من أجل إبعادها عن ايران وفشلت في ذلك، من أن تستعمل الإسلاميين الجهاديين من أجل صب الزيت على الحريق السوري في فترة 2012-2015 إما من أجل “تغيير سياسات النظام” أو من أجل إسقاطه. تحولت الأزمة السورية من محلية إلى دولية – اقليمية مع دخول روسيا وإيران من أجل منع تلك الدول من تحقيق أهدافها في سوريا.
المصدر: نورث برس
- محمد سيد رصاص كاتب سوري