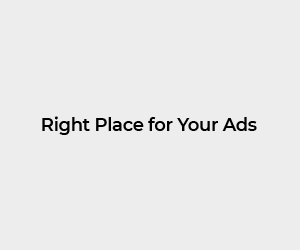السبت 17 نيسان/أبريل 2021
أنهت ثورات الحرية والتحرير في مصر العربية في الثالث والعشرين من تموز/يوليو 1953 بقيادة جمال عبدالناصر ضد الاستعمار البريطاني والملك فاروق، وثورة الجزائر بقيادة أحمد بن بيلا عام 1956 ضد الاستعمار الفرنسي والجنوب في عدن بقيادة عبدالفتاح إسماعيل ضد الاستعمار البريطاني، حقبة الاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي في المنطقة، بل إن هناك موجة من الثورات الأخرى، مثل ثورة اليمن ضد الإمام أحمد الرجعي، بقيادة المشير عبد السلال عام 1962 وثورة الفاتح من أيلول عام 1969 بقيادة معمر القذافي ضد الاستعمار البريطاني والنظام الرجعي، مقدمة وثورة 14 تموز 1964 في العراق بقيادة عبدالسلام عارف ضد الاستعمار البريطاني ونظام نوري السعيد وحلف بغداد، كان لها الفضل في طي صفحة الرجعية في العالم العربي.
ولم يعد مبدأ الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور في خمسينات القرن الماضي، بعد هذه الثورات العربية الجماهيرية قائماً على الأرض، بعد أن انتهت أذرع حلف بغداد أيضاً؛ إذ شكلت هذه الحقبة من تاريخ المنطقة نقطة تحول للوعي الجماهيري ضد كل المشاريع التي تحاط لها.
نستعرض مسيرة هذه الثورات، وفي الوقت ذاته نعكس الصورة المقابلة لهذه الثورات لاحقاً، إذ انحرف مسار هذه الثورات عن مسارها الشعبي وأخذت أشكالاً سياسية واجتماعية واقتصادية لا تلائم طموحات وتطلعات الجماهير آنذاك، واتخذ قادة هذه الثورات مسارات أخرى قادت المنطقة إلى وبال مازالت تدفع ثمنه حتى اللحظة، وكانت بداية الانحراف من اتفاقية كامب ديفيد لما يسمى بالسلام بين مصر وإسرائيل في فترة حكم الرئيس المصري أنور السادات، أما في دول الثورات “السابقة” مثل ليبيا وفي اليمن وفي الجزائر وفي تونس وفي السودان وفي سوريا، اتجهت إلى إعادة نهج الاستبداد والتوريث واحتكار السلطة والفساد وحكم الحزب الواحد، فضلاً عن الخلل الاجتماعي والبطالة والفقر والهيمنة الخارجية.
كانت الصدمة كبيرة على شعوب المنطقة التي ناضلت من أجل الحرية الديمقراطية وبناء دولها التي خرجت جريحة من حقب الاستعمار طوال عقود، لكن الحال لم يستمر في ظل هذه الأنظمة التي ابتعدت عن ضمير وتطلعات شعوبها، وكانت النتيجة انطلاق ثورات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في تونس ومصر العربية، الدولتين اللتين حالفها الحظ بوقوف الجيش الوطني في البلدين على الحياد وتعاطفه معها، ونتيجة الحالة التاريخية بين هذه الدول وطبيعة العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتشابهة، امتدت الثورات إلى سوريا، حيث حافظت الثورة على سلميتها لمدة ستة أشهر رغم قمع الأمن وإطلاق سراح الضباط المنتمين تنظيمات إسلاموية متطرفة مصنفة إرهابياً، وتدخلت تنظيمات وميليشيات طائفية من دول الجوار تابعة للحرس الثوري التابعة لنظام ولاية الفقيه وتبعتها تنظيمات إرهابية (جهادية) مسلحة، لتسود الفوضى والعنف والمجازر وقطع الرقاب والقتل في بعض الأحيان على الهوية أو العرق.
هذا المشهد العبثي والمختلط، وأمام فوضى السلاح الذي سببه النظام وصعود التطرف والتطرف المضاد، أخذ النظام الذريعة لقمع الثورة السلمية بالعنف والاعتراف والتعذيب والتصفيات الجسدية بدعم الحرس الثوري بحجة محاربة الإرهاب وإعطاء الذريعة للتدخل العسكري للتحالف الدولي الغربي والإقليمي بحجة محاربة الإرهاب أيضاً، بل دخل الكيان الاسرائيلي على خط الثورة السورية للقيام بغارات جوية عدوانية على الأراضي السورية لضرب المنشآت والمعسكرات والقواعد التابعة للحرس الثوري والميليشيات الموالية، كانت هذه النتيجة الطبيعية لسلوك النظام الذي اتخذ منذ اللحظة الأولى قرار الحل الأمني.
هذه العواصف الهوجاء التي تعصف بالوطن والشعب السوري، أدت إلى أكبر كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين بحسب اعتراف الأمم المتحدة، إذ تهجر من سوريا أكثر من 10 ملايين إلى دول الجوار وأوروبا، بينما تم ضرب بنية الجيش السوري وإضعافه بعد سلسلة من الانشقاقات وموجات الفرار الداخلي والخارجي من حرب أهلية عبثية، رافق ذلك الاستعانة بميليشيات غير منضبطة خارجة عن منظومة الجيش بسبب عجز النظام عن تأمين احتياجات الجيش خلال حروبه العسكرية، ما دفع للزج بميليشيات مهمتها القتال والاستيلاء على أملاك المدنيين وضحايا الحرب دون ضوابط، وفي كثير من الأحيان تم تهميش الجيش على حساب الميليشيات الإيرانية والمحلية.
ولم يكتفِ النظام بالتمسك بالحل العسكري، بل بقى على موقفه الرافض للحل السياسي التفاوضي انطلاقاً من بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة والقرار 2254، ما زاد الأمور تعقيداً وعمّق الأزمة.
وكانت النتيجة، أن دفعت سوريا نتيجة كل ما دار على أرضها بسبب ممارسات النظام، وتحولت سوريا إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية والتدخلات العسكرية والميليشيات المذهبية والمرتزقة والهجمات الصاروخية والغازات العدوانية الإسرائيلية وتعرض الوطن للتجزئة والتقسيم، وأصبح مرتع التنظيمات الإرهابية في البادية السورية والخلايا النائمة في الشرق والشمال الشرقي وفي مناطق شرق وغرب الفرات وريفي حلب وإدلب وشمال اللاذقية، ولم تعد سوريا التاريخية كما نعرفها نتيجة كل عمليات التخريب والتشويه.
في ظل كل ما جرى ويجري في سوريا، فإن هذا يزيد من حجم المسؤولية الوطنية على جميع قوى الثورة والمعارضة مدنية وعسكرية والقوى الوطنية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني أمام مسؤوليتها الوطنية في مواجهة هذه التحديات والأخطار. ولعل المؤتمر التأسيسي (لجود)، ولد من رحم سنوات الحرب العشر الماضية وتشتت المعارضة السورية، إذ كان الهدف الأول لمؤتمر جود هو جمع أوسع طيف من المعارضة السورية في الداخل والخارج، إلا أن سطوة الأجهزة الأمنية السورية منعت عبر الأجهزة الأمنية انعقاد هذا المؤتمر الوطني، لتزيد من تمزق البلاد مرة أخرى.
ومع ذلك لا خيار أمامنا كمعارضة سورية، إلا التمسك بخيار الوحدة في مؤتمر وطني موسع، من شأنه أن يؤدي إلى بناء سوريا الدولة المدنية الديمقراطية، وفق مقدراتها التاريخية وتطلعات شعبها الذي عانى على مدار السنوات العشر الماضية، فالتجربة العربية في الثورات منذ نهاية حقبة الاستعمار، تؤكد أن ركائز الاستقرار هي تحقيق تطلعات الشعوب ويناء الدول الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع على أساس المواطنة.
المصدر: نورث برس
- حسن عبد العظيم سياسي سوري معارض